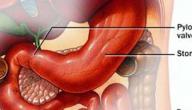محتويات
جرثومة المعدة
يُطلق على جرثومة المعدة أيضًا اسم بكتيريا المعدة، أو البكتيريا الملوية البوابيّة، وهي بكتيريا سالبة الجرام على شكلٍ حلزونيّ، يمكن أن تسبّب التهابًا مزمنًا في بطانة المعدة الدّاخلية، وفي الاثني عشر؛ أي الجزء الأوّل من الأمعاء الدّقيقة في الإنسان، كما تعدّ هذه البكتيريا سببًا شائعًا للقرحة في جميع أنحاء العالم؛ فما يصل إلى 90 ٪ من المصابين بالقرحة مصابون بالبكتيريا الحلزونيّة، ومع ذلك فإنّ العديد من الأشخاص توجد لديهم هذه البكتيريا في المعدة والجهاز الهضميّ العلويّ دون ظهور أعراض، أو أنها قد تكون قليلةً.[١].
آثار جرثومة المعدة
أغلب المصابين بجرثومة المعدة لن يلاحظوا وجود أيّ أعراضٍ أو علامات، وما زال لا يُعرف سبب ذلك، إلّا أنّ بعض الأشخاص قد يُولَدون بمقاومةٍ مرتفعة للأعراض الضارّة لجرثومة المعدة، وفي حال حدوث أي أعراضٍ أو علامات بسبب عدوى جرثومة المعدة فقد تشمل ما يأتي[٢]:
- حكّة أو ألم حرقة في البطن.
- التّجشؤ المتكرّر.
- زيادة ألم البطن سوءًا إذا كانت معدة المريض فارغةً.
- الغثيان.
- فقدان الشّهية.
- انتفاخ البطن.
- فقدان الوزن غير المقصود.
كما يجب مراجعة الطّبيب عند ملاحظة أي علاماتٍ وأعراض مستمرّة قد تسبّب القلق، ومن هذه العلامات والأعراض:
- ألم حادّ في البطن أو مستمرّ.
- صعوبة في البلع.
- وجود براز دمويّ أو أسود قطرانيّ.
- وجود قيء دمويّ، أو أسود، أو قد يشبه القهوة المطحونة.
طرق الإصابة بجرثومة المعدة
ما زال السّبب الدّقيق للإصابة بجرثومة المعدة غير معروف، لكن في بعض الحالات قد يكون الغذاء أو الماء الملوّثين مسؤولين عن ذلك، كما أنه عُثِر على وجود جرثومة المعدة في اللعاب البشري، لذلك يعتقد الخبراء أنّها قد تكون قادرةً على الانتقال من شخصٍ إلى آخر، ولا توجد طريقة معروفة أو أكيدة لمنع الإصابة بجرثومة المعدة، لكن يوصي الخبراء بما يأتي[٣]:
- غسل اليدين قبل الأكل وبعد استخدام الحمّام.
- شرب فقط مياه شرب نظيفة وآمنة.
- تناول الطّعام المُعدّ بأمان.
تعدّ العدوى بجرثومة المعدة شائعةً في البلدان النّامية، إذ قد لا يتمكّن النّاس من الحصول على طعام أو ماءٍ نظيفٍ وآمن.
علاج جرثومة المعدة
تُعالَج جرثومة المعدة عادةً باثنين على الأقلّ من المضادّات الحيويّة المختلفة في آنٍ واحد؛ للمساعدة على منع البكتيريا من تشكيل مقاومةٍ لأحد المضادّات الحيويّة المعينة، إذ يصف الطّبيب دواءً مثبّطًا لحمض المعدة؛ للمساعدة على علاج بطانة المعدة، وتشمل الأدوية التي يمكن أن تثبّط حمض المعدة ما يأتي:[٢]:
- أدوية مثبّطات مضخّة البروتون: تساعد هذه الأدوية على وقف إفراز الحمض في المعدة، وبعض الأمثلة على مثبّطات مضخّة البروتون إيسوميبرازول، ولانزوبـرازول، وبانتوبرازول.
- أدوية حاصرات الهيستامين (H-2): تثبّط هذه الأدوية مادةً تسمّى الهيستامين، والتي تحفّز إفراز حمض المعدة، ومن الأمثلة التي تتضمّنها هذه الأدوية سيميتيدين، ورانيتيدين.
- دواء بسموث السبساليسيلات: يعمل هذا الدواء عن طريق تغليف القرحة وحمايتها من الحمض المَعدي.
كما قد يوصي الطّبيب بإجراء تحاليل مخبريّة لجرثومة المعدة بعد أربعة أسابيع على الأقلّ من الالتزام بالعلاج، فإذا أظهرت التّحاليل المخبرية أنّ العلاج غير ناجح فقد يخضع المريض لدورةٍ أخرى من العلاج بمزيجٍ مختلف من المضادّات الحيويّة.
تشخيص جرثومة المعدة
تتضمّن التّحاليل المخبرية والإجراءات المستخدمة لتحديد ما إذا كان الشّخص مصابًا بعدوى جرثومة المعدة أم لا ما يأتي[٢]:
- تحليل الدّم: قد يكشف تحليل الدّم دليلًا على وجود عدوى نشطة أو سابقة بجرثومة المعدة في الجسم، وتعدّ فحوصات البراز والتنفّس أفضل تحليل لرصد عدوى جرثومة المعدة بالمقارنة مع تحليل الدّم.
- فحص التنفس: يبتلع المريض سائلًا، أو حبّةً، أو حلوى البودينج، وجميعها خيارات تحتوي على جزيئات الكربون، فإن كان الشّخص مصابًا بعدوى جرثومة المعدة فسينطلق الكربون عند انحلال المحلول في المعدة، ويمتصّ الجسم الكربون ويطرده عند الزّفير، فعند الزّفر في كيس يستخدم الطّبيب جهازًا خاصًا لتحديد وجود جزيئات الكربون، كما يمكن للأدوية المثبّطة للحمض المعروفة باسم مثبّطات مضخة البروتون وبسموث سبساليسيلات والمضادّات الحيويّة أن تتداخل مع دقّة هذا الفحص، لذلك يطلب الطبيب إيقاف استخدام أنواع هذه الأدوية لأسبوعٍ أو اثنين قبل الخضوع للفحص، ويمكن إجراء هذا الفحص للبالغين والأطفال.
- فحص البراز: يُجرَى هذا الفحص في المختبر، ويسمّى فحص مستضدّ البراز من البروتينات الغريبة المرتبطة بعدوى جرثومة المعدة في البراز، ومثل فحص التنفّس فإنّ أدوية مثبّطات مضخة البروتون وبسموث السبساليسيلات يمكن أن تؤثّر على نتيجة هذا التحليل، لذلك يطلب الطّبيب وقف استخدامها لمدّة أسبوعين قبل إجرائه.
- فحص المنظار: يتلقّى المريض مهدئًا لهذا الفحص، والذي يُعرَف بفحص التّنظير الباطني العلوي، وخلاله يمرّر الطّبيب أنبوبًا طويلًا مرنًا مجهّزًا بكاميرا صغيرة إلى أسفل عبر الحلق والمريء وصولاً إلى المعدة والاثني عشر، وتتيح هذه الأداة للطبّيب معاينة أي شذوذ في الجهاز الهضمي العلوي وإزالة خزعةٍ من الأنسجة.
المراجع
- ↑ "H. pylori Infection", www.medicinenet.com, Retrieved 23-05-2019. Edited.
- ^ أ ب ت "Helicobacter pylori (H. pylori) infection", www.mayoclinic.org, Retrieved 23-05-2019. Edited.
- ↑ "What's to know about H. pylori?", www.medicalnewstoday.com, Retrieved 23-05-2019. Edited.